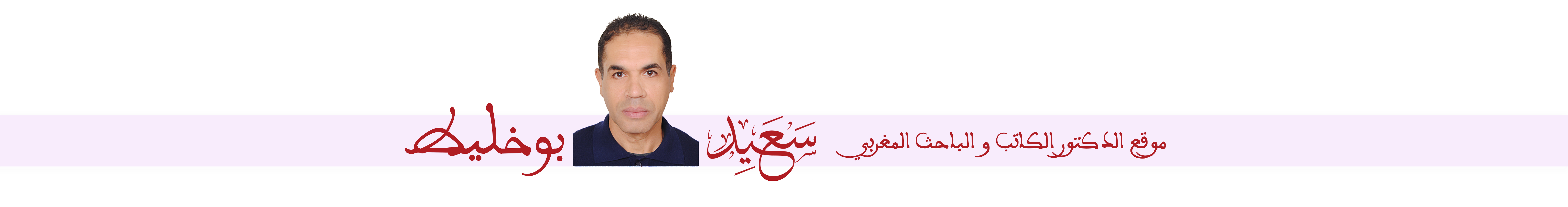
ربّما لو لم يكتب عبد الرحمن منيف دراسته :''مروان قصاب باشي،رحلة الفن والحياة'' وإصدارها سنة 1996،ثم تبادل صحبة بطل تلك الدراسة جملة رسائل طويلة شخصية قارب عددها الثّلاثين اكتشفها القارئ العربي سنة 2012 بين طيات كتاب عنوانه : ''في أدب الصداقة عبد الرحمن منيف ومروان قصاب باشي''،بمبادرة من زوجة منيف سعاد قوادري وكذا قصاب باشي بعد وفاة مبدع مدن الملح سنة.2004
في حالة انعدام هاتين الوثيقتين،من المحتمل أن يظلّ اسم الرسّام والنّحات السوري مروان قصاب باشي،غير معروف،سوى لدى أقليّة من صفوة المهتمّين بتاريخ الفنّ والتّشكيل.
إشارة تعيد حقيقة طرح أهمّية الكتابة وجوديا والتخلّص قدر الإمكان من كسل التّداول الشفوي السطحي والعابر،وقد ترسّخ تقليده للأسف أكثر وصار واقعا قائم الذات مع تراكم عقود أدبيات الرّقمنة التي قوّضت جذريا مختلف القيم المرتبطة بتأمّل الأفكار ومحاورتها بتؤدة ورويّة وعمق ضمن بوح مونولوغ أساسه عزلة بياض الورق.
بالتأكيد الكتابة حيوات متجدِّدة،ولادات مستمرّة،صياغات لاتنتهي، تلاحق جدلية الحياة والموت،التّلاشي والانبعاث.قد يقول قائل،يكفي مروان قصاب باشي تراثه الفني على مستوى التّشكيل والنّحت التي انطلقت حلقاته منذ الخمسينات غاية وفاته سنة 2016، فأضحى اسما عالميا احتضنت لوحاته ومنحوتاته أرقى المؤسّسات الدولية والصّالونات الفنّية في ألمانيا وأمريكا وانجلترا، ملهِما أجيالا من الفنانين بل واعتُبرت تراكمات هذا المنجز مدرسة بجانب مدارس الفن المعاصر،يلزم مع ذلك الإقرار بأنّ منيف ساهم عربيا في استعادة هويّة قصاب باشي،وإعادة تسليط الضّوء قوميا على هذا المبدع،وقد تبلورت روافد استيهاماته الخلاّقة بين رؤى عزلة جليد وصمت برلين ثم حنين دفء حميمة أمكنة طفولة دمشق.
عند محاولة التّأريخ لتراكمات درس النّحو العربي،يظهر باستمرار سيبويه باعتباره المرجع الأوّل والسّند الأصلي،في حين يبقى اسم الخليل بن أحمد الفراهيدي بداية المشروع الحقيقي لدراسة اللغة العربية نسقيا،تركيبيا وصوتيا،وفق رؤية متكاملة تبلورت منهجيا وعلميا،قياسا لما فعله أبو الأسود الدؤلي،باعتباره أوّل مبادر كي ينحو من هذا النحو بتوجيه من الإمام علي بن أبي طالب"ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت''،سعيا إلى حماية القرآن واللغة العربية نتيجة اختلاط العرب بالأعاجم في أمصار العراق، بعد أن شاع اللّحن ولاسيما قراءة أحدهم الآية : "إن الله بريء من المشركين ورسولِهِ"(بكسر اللام)،أو بما فعله سيبويه خلال القرن الثاني عندما قنّن وهيكل بنيويا مختلف الاجتهادات المتواترة سابقا،يظلّ حقيقة الخليل بن أحمد الفراهيدي عقلا جبّارا ومبدعا نَظَمَ شتات النحو وصار علما وفق الصورة التي نعاينها بين صفحات الكتب التعليمية التراثية:''مؤصّل علم النحو العربي وواضع مصطلحاته، وباسط مسائله،ومسبّب علله، ومفتّق معانيه، أستاذ أهل الذكاء والفطنة، مكتشف علمي العروض والقافية، الموسيقى، الرياضي، المعجمي، المحدِّث النحوي اللغوي ''(1).
هكذا،يعتبر الخليل أستاذا لسيبويه،الذي استثمر كثيرا من خلاصات زعيم مدرسة البصرة وواضع علم العروض والقافية وكذا أول معجم في اللغة العربية،ناقلا إيّاها مرة بالإحالة الصريحة وأحيانا أخرى بكيفية ضمنية.يقول الزبيدي عن ريادة الفراهيدي:''وهو الذي بسط النحو ومدّ أطنابه وسبب علله وفتق معانيه وأوضح الحجاج فيه،حتى بلغ أقصى حدوده وانتهى إلى أبعد غاياته،ثم لم يرض أن يؤلّف فيه حرفا أو يرسم منه رسما ترفعا بنفسه وترفعا بقدره إذ كان قد تقدم إلى القول عليه والتأليف فيه،فكره أن يكون لمن تقدمه تاليا،وعلى نظر من سبقه محتذيا.واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه،ولقنه من دقائق نظره ونتائج فكره ولطائف حكمته،فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده وألّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله،كما امتنع على من تأخر بعده''(2).
وردت على لسان سيبويه المسائل النحوية التي أدلى بها الفراهيدي،واستشهد باسمه خلال مايقارب ثلاثمائة وثمانين قضية لغوية،مثلما أحال سيبويه ضمن ذات المقام على شيوخ وأئمّة آخرين مثل عِيسَى بْنُ عُمَرَ الثَّقَفِي ويونس بن حبيب.
ما الذي يحدث للحالم حين تأمّله وحيدا لهيب شعلة؟كيف يعيش تلك اللحظة الوجودية المتميّزة إنسانيا؟فالشّعلة تستدعي التأمّل الشارد من بين كل أشياء العالم،وتعدّ بالتالي إلهاما للصور أو تحديدا أكبر متعهِّد لها حسب توصيف غاستون باشلار،مادامت تحفِّزنا في المقام الأول على التّحليق بخيالنا،ويفتقد العالم المرئي وضعه لصالح مجازات الصور المتأمّلة.
لذلك، وبهدف الوصول إلى هذا الزّخم الحُلُمي، أبان باشلار منذ البداية عن رغبته كي يقارب موضوع الشّعلة دون التقيّد بمرجعية محدّدة أو إطار مرجعي معين.مثلما، تحاشى إغواء تحويل حديثه عن الشعلة إلى كتاب معرفي.
مقابل انقياد الفيلسوف خلف عموميات كليّة،ينبغي تحريض خيال الشّعلة حسب أفق تعدّد الصور التي تحوِّل المجازات الفاترة إلى صور،وتمثِّل بداية حياة أولى للخيال ومغادرة العالم الواقعي وجهة آخر متخيّل وفق صيغته المطلقة أي التأمُّل الشارد الشعري.عندئذ، وفي خضمّ سعادة الحالم بتأمّله الشّارد،يمسك من جهة بحقيقة الوجود وكذا المصير الإنساني.
يصير كل حالم أمام الشّعلة،حتما شاعرا وقد وجد نفسه أمام تأمّل شارد أوّلي، مذهل،يجد امتداداته بين طيّات ماض سحيق،يجعله حسب باشلار انجذابا فطريا ومتأصِّلا داخل نفسية الحالم :''تدعوني الشُّعلة كي أرى للمرَّة الأولى مكمن آلاف الذِّكريات،وأحلم من خلالها بمجمل شخصية ذاكرة شائخة جدا مع ذلك أحلم بها مثل الجميع،وأتذكَّرها مثلما يتذكَّر الجميع،بالتالي يعيش الحالم تبعا لإحدى قوانين التأمُّل الشَّارد الأكثر ثباتا إزاء الشُّعلة،عند ماض ليس فقط ماضيه،بل ماضي أولى نيران العالم''(1).
توقّفت حقيقة ذاكرتي عن ترسيخ سيمياء المدرّسين؛وترميم أشلاء مابقي عالقا،مع نهاية حقبة حصولي على الباكلوريا.في المقابل،لم تعد لذات الذّاكرة نفس الانهماك خلال سنوات الجامعة مطلع التّسعينات،وصارت مكتفية تماما بالماضي البعيد جدا في خضمّ عوالم الأمس.
*نهاية مأساوية :
كان المدرِّس الوحيد الذي يأتي إلى المدرسة،بلا محفظة أو تحضيرات أو مجرّد ورقة دالّة تطويها يده.يمرُّ بداية إلى الإدارة كي يحمل حفنة من الطبشور ذي الألوان المتباينة.يرتدي وزرته.يشرع ولم ينبس بكلمة واحدة في ملء السبّورة من ألفها إلى يائها بالمعادلات الرياضية.يهمس في نفسه،ولايلتفت قط وجهة التّلاميذ أو حتى الانتباه لبعض إشاراتهم،بل فقط مصوِّبا اهتمامه كليّا نحو مايكتبه بكيفية متسارعة.
ينتهي.يقذف بجزئية الطبشور صوب السّقف أو الباب،مع تلفُّظه دائما بلازمة''إلى الجحيم أيّها العالم !''.يدسّ يديه في جيبي وزرته.يتسمَّر خارج الحجرة أو بمحاذاتها قليلا. يشعل سيجارة على طريقة نجوم أفلام الويستيرن؛يطفئ الوقود كما تُطفأ شموع عيد الميلاد.يأخذ نَفَسا عميقا.يحدّق في السماء طويلا.
كان أستاذا موهوبا في الرّياضيات،متخلِّصا من بروتوكولات التّدريس المألوفة.لم يعرف عنه مناداته لتلميذ باسمه؛غير مهتمٍّ بهذه التفاصيل وإن درس عنده أحدهم لأكثر من سنة.الجوهريّ بالنسبة إليه،تركيزه على السبُّورة كي يسقط مجمل هواجسه عبر تحليل المعادلات.
مرّت سنوات.شاءت الصُّدف أن أقطن منزلا غير بعيد عن سَكَن هذا المدرّس. طبعا،رغم طول الفترة،انقشعت بسرعة البرق ملامح شخصيته التي مرّت عليها آنذاك اثنا عشر سنة،بمجرّد أن رمقتُ طيفه عابرا بجواري رغم التغيُّرات الجذرية التي رسمت حضوره الجديد بَدَنيا ومظهريا؛قياسا لما كان عليه خلال زمن المدرسة.غير أنّها هيئة لم تكن عادية بل تستدعي الارتياب.جاء حدسي صائبا.باستغراب شديد،بدأتُ أعاين تواجده غير ما مرّة جالسا صحبة جماعة من ''المتشرِّدين''منغمسا في أحاديث على ترانيم قارورات كحولية من النّوع السَّيئ جدّا.
لم تكد تمضي حقبة قصيرة على الرّصد العجيب،حتى سمعتُ ذات ظهيرة زعيقا وعويلا من داخل منزله : مات عاشق الرياضيات بعد نهاية سوريالية تماما،اختبر خلالها التشرّد والإدمان،رغم وضعه المهني والرّمزي.
*أكلة التّمر المفضَّلة :
عرفتُ هذا المدرِّس المولع بفاكهة التَّمر،نهاية الطّور الابتدائي.لاحظت وزملائي التلاميذ دائما انتفاخ واكتناز جيب جلاَّبيته بحفن التّمر،لايتوقّف عن رميها بسرعة في فمه طيلة الحصص،كأنّه قوت يلهمه سحر قواعد اللغة العربية التي يعشقها بشكل ملحوظ للغاية.
حضر إلى الحجرة الدراسية باكرا قبل مجيئنا بفترة.يملأ السبُّورة بنصٍّ طويل كتبه بخطٍّ جميل.بعد استواء التلاميذ على مقاعدهم،يتناول عصاه الطويلة والرّفيعة ويشرع في الإشارة على بعضنا قصد تشكيل النصِّ وإعراب بعض جمله،مع استمرار تناوله التّمر. خلال إحدى المناسبات،كاد أن يفقد حياته أمامنا،عندما انفعل بطريقة زائدة وفي فمه ثمرة،فقد استشاط غضبا لأنَّ تلميذا أخطأ تقدير حركة إعرابية.كادت نواة،أن ترضيه قتيلا، لولا تداركه الأمر بعد ثوانٍ لم تكن هيِّنة مثلما تابع كلّ الفصل.
*نظَّارة طه حسين :
لم يكتشف قط أيّ تلميذ عيني مدرِّس اللغة الفرنسية،خلال السنة الثَّالثة من التّعليم الابتدائي أواخر السّبعينات،على الأقلّ،إبّان تلك الحقبة من انتمائي إلى المدرسة.فضاء اشتهر أيضا،بحفرة مظلمة كبيرة مخيفة تشغل الواجهة الخلفية.قيل لنا آنذاك،كي نبتعد،بأنّها مأوى غول عظيم لايغادر الحفرة سوى ليلا.زاد ثِقَل رعب هذا الأمر على نفوسنا كأطفال،أنَّنا صادفنا بين الفينة والأخرى،عظاما بشرية فجّرت إشاعات جانبية تؤَكِّد استيطان هيكل المدرسة على أطلال مقبرة قديمة.
إذن،يسود بجانب ذلك خوف دائم من أشكال العقاب التي يمارسها في حقّ التلاميذ، المدرِّس الذي لم يزح قط نظّارة سوداء تحجب عينيه تماما،واستحال معرفة سرّه : العمى؟ الحَوَل؟عيب خلقي ؟رغم انسياب نسيج جملة تأويلات عبر آذان التلاميذ خلال فترات الاستراحة،بأنّ الأمر لاعلاقة له بالاحتمالات السّابقة،بل مجرّد حيلة للتَّمويه تحديدا عن وجهة نظراته كي يرصد شغب بعضنا، والويل لمن رصده سواد الزّجاجتين.