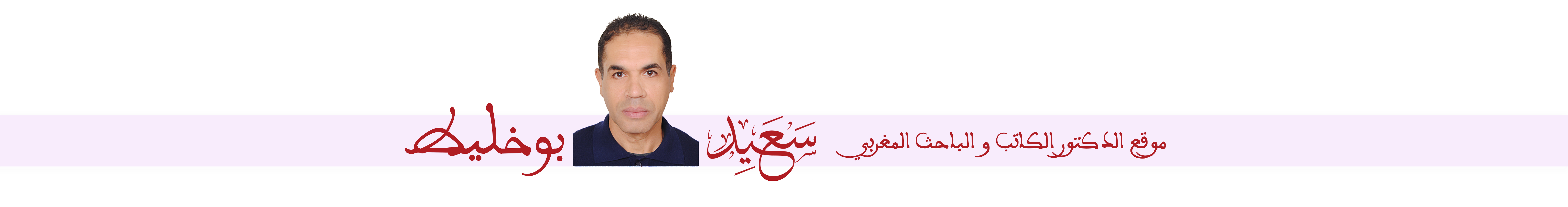
''شعلة مضطربة مُجَنَّحة،آه من نَفَسٍ أحمر، يعكس السّماء ويستكشفُ سِرَّكَ وما ستكونه موتكَ وحياتكَ''(مارتن كوبيش،أنطولوجية القصيدة الألمانية،ترجمة رونيه لازن وجورج رابوز،الجزء الثاني،ص 206 ).
خلال زمن سابق،عبر ذات الأحلام المنسية،أثار لهيب شمعة تفكير الحكماء؛وبعث لدى الفيلسوف المنعزِل آلاف الرُّؤى.فوق طاولة فيلسوف،بمحاذاة أدوات أخرى محتَجَزة ضمن إطار قالبها،ثم كُتُب تعلِّم بتؤدة،تستدعي شعلة قنديل أو شمعة أفكارا بلا منتهى،تثير صورا على نحو غير محدود.لقد شكَّل ذلك اللّهيب ظاهرة للعالم،بالنسبة لحالم بالعوالم.
ندرس نظام العالم بين طيّات كُتُب ضخمة ثم هاهي شعلة بسيطة – تستهزئ من المعرفة !– أمكنها فورا طرح لغزها الخاص.أليس العالم حيّا،مع فتيل لهيب شمعة؟ألا تمتلك حياة؟ألا تجسِّد إشارة مرئية عن كائن حميمي،وقوة سرّية؟ألا تنطوي هذه الشّعلة،على مختلف التّناقضات الباطنية التي تضفي ديناميكية على ميتافيزيقا أوّلية؟لماذا البحث عن جدليات الأفكار،ونحن نتواجد في قلب ظاهرة بسيطة عن جدليات الوقائع،والكائنات؟الشّعلة كائن بلا كتلة ومع ذلك تعتبر قويّة.
ماحقل المجازات الواجب اختباره إن توخّيْتُ،في إطار ثنائية صور توحِّد بين الحياة والشّعلة،كتابة ''تحليل نفسي"للشُّعل وكذا ''فيزياء'' لنيران الحياة !مجازات؟خلال سياق تلك الحقبة السّحيقة حينما كانت الشّعلة تحثُّ الحكماء على التَّفكير،وبلورت المجازات فكرا.
لكن تستمرّ قيمة التأمّل الشّارد،رغم موت المعرفة التي تطويها الكتب الشّائخة.سأحاول عبر صفحات هذا الكتاب الصغير،تسليط الضوء على وثائق شتّى نسجها خيال تأمّل شارد أوّلي،راكمتُها من متون الفلاسفة أو الشُّعراء.يصير كلّ شيء لنا ومن أجلنا، حين العثور ثانية على جذور البساطة ضمن رؤانا أو تواصل رؤى الآخرين.نتواصل أخلاقيا مع العالم بجوار شعلة.بكل بساطة، يغدو لهيب شمعة خلال سَمَرٍ،نموذج حياة هادئة ولطيفة.حتما، يشكِّل أدنى نَفَسٍ إزعاجا لها،مثلما يفعل فكر غريب على وقع تأمُّل فيلسوف متأمِّل.لكن عندما تتأتّى فعلا سيادة العزلة الكبيرة، وتدقُّ حقّا ساعة الهدوء،حينها يسكن نفس السلام فؤاد الحالم والشّعلة، بينما تحتفظ الشُّعلة على هيئتها وتمضي نحو مصيرها العمودي، حسب خطٍّ مستقيم، مثل فكر صارم.
هكذا،إبّان أزمنة كنا نحلم ونحن نفكِّر،مثلما نفكِّر ونحن نحلم،أمكن للهيب شمعة أن يقدِّم قياس ضغط ملموس عن هدوء الرُّوح، ومقياسا عن هدوء ناعم،يمتدّ غاية تفاصيل الحياة، يمنح نعمة استمرارية الفترة التي تعقب مسار تأمّل شارد مريح.هل ترغب في الطُّمأنينة؟ تنفَّس برفق أمام شعلة رشيقة تبلور بهدوء صنيع نورها.
تقديم : ولد عاموس عوز،في القدس سنة 1939،بين أحضان عائلة يهودية بولونية هاجرت إلى فلسطين نتيجة الاضطهاد.تحتفظ ذاكرته عن القدس خلال تلك الحقبة،بصورة مدينة ميّزتها''فسيفساء ثقافية''.إبّان سنوات مراهقته،انتقل إلى مستوطنة''هولدا كيبوتس''،فاختبر حياة مفعمة ب"الأخوّة''.
بعد دراسات أدبية وفلسفية،شارك سنة 1967 في حرب الأيّام الستّة،ثم انضمّ إلى صفوف حركة ترفض كلّ ضمّ قسري.أصدر روايته الأولى''هناك ربّما''(1971). العودة ثانية إلى الجبهة العسكرية خلال حرب كيبور(1973) ،قبل تأسيسه سنة(1977)صحبة مثقّفين إسرائيليين آخرين حركة''السّلام الآن''،التي ناضلت من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية،والعودة إلى حدود 1967 وكذا إخلاء المستوطنات.
اعتُبر عاموس عوز لفترة طويلة،أحد النّاطقين باسم اليسار الإسرائيلي و حركة ''السلام الآن''،ومدافعا عن قيام دولة فلسطينية.
تواصلت إصداراته الرّوائية باللغة العبرية،لكنها تُرجمت إلى مختلف لغات العالم مثلما الشأن مع روايته''العلبة السوداء''التي فازت بجائزة فيمينيا سنة (1988). كذلك،عرفت روايته الأخرى''تاريخ الحبّ والعتمة''نجاحا عالميا كبيرا.
بحكم سلطته المعنوية داخل إسرائيل،ساهم في النّقاشات التي أفضت نحو اتّفاق جنيف شهر دجنبر 2003،فاصدر كتابه/البيان تحت عنوان :''ساعدونا على الطّلاق!إسرائيل فلسطين،دولتان حالا''.
توفيّ عاموس عوز،أحد أكبر أدباء إسرائيل،يوم 28 دجنبر 2018عن سنّ التّاسعة والسبعين،بعد معاناة مع مرض السرطان.ترك عملا أدبيا حظي بجوائز،قوامه عشرين رواية ومجموعات قصصية،إضافة إلى عدد من الدّراسات وجملة مقالات صحفية.
التقيته بعد شهور من حفل توقيع عمله المعنون ب''مبادرة جنيف ''يوم 1 دجنبر 2003 حول السّلام،اتّفاق تاريخي شامل بخصوص حقوق الدّولتين،اليهودية والفلسطينية،داعيا إلى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة،وتقاسم السّيادة على القدس،وضع لم يتمّ تفعيله سوى جزئيا جدا.
دعوة رفضها على الفور أرييل شارون والليكود،معتبرين الأمر''خطيرا على إسرائيل''.بدورها،لم تكترث حماس بكلام عاموس عوز ووصفت مضمونه ب''الخيانة''.
من المهمّ اليوم إعادة قراءة هذا الحوار،الذي تبلورت معالمه مباشرة بعد صدور كتاب عاموس عاوز :''ساعدونا على الطّلاق! دولتان الآن''(غاليمار،2004 )،منتقدا بشكل حادّ''النّزعة المثالية المفرطة''للمثقّفين الفرنسيين المدافعين عن الفلسطينيين دون استيعاب للمواقف الإسرائيلية على مستوى الدّفاع عن الذات،لكن في إطار دعم قوي لاستراتجية ''تسوية مؤلمة''بين إسرائيل والفلسطينيين تفضي نحو الاعتراف بوجود الدولتين،السّبيل الوحيد الممكن في نظره،وكذا مناصري حركة ''السلام الآن''.
أمل ضعيف،تدعمه فرنسا منذ فترة،يبدو اليوم في تصوّر بلدان عديدة مخرجا وحيدا من أجل وضع نهاية للوقائع الدموية التي اندلعت شرارتها نتيجة هجمات حماس يوم 7 أكتوبر 2023 (1195قتيلا،و 250رهينة)،ثمّ التّدمير الممنهج واللا- إنساني لقطاع غزة من طرف الجيش الإسرائيلي(67.000 قتيلا مدنيا،160.000 جريحا،وفق الإحصائيات التي وفَّرتها غاية الآن وزارة الصحة في غزة،الموثوق بها دوليا).
حاليا،بداية سريان مفعول وقف النّار ومخطّط السّلام الذي أعلنت عنه إدارة دونالد ترامب.يوم الجمعة 10 أكتوبر،أكّد الجيش الأمريكي بأنّ القوّات الإسرائيلية شرعت في الانسحاب من غزة،وكذا عودة أكثر من مائتي ألف فلسطيني يوم السبت إلى شمال القطاع.حماس بدورها التزمت بقرار إطلاق سراح الرّهائن الإسرائيليين ابتداء من ظهيرة يوم الاثنين.ربما يعرف مشروع السّلام انطلاقة بعد مذبحة استمرّت شهورا.
تر كّز عيناه الزرقاوان على مايجري حوله،يستعجل عاموس عوز الإقناع،يعشق السّلام بكيفية عنيدة،حضر كضيف شرف للتّظاهرة الثقافية الكبرى ''كوسموبوليس''التي تنظّمها مدينة برشلونة سنويا واختارت هذا العام موضوع الحرب،هكذا تضاعفت اللقاءات والمداخلات الحارقة.لم يأت ل''النّميمة''،بل كي يرافع،يناضل،يباغت ثم يسخر.يرغب في إسماع الأوروبيين الرّسالة السياسية لحركة "السّلام الآن''،التي اختزلها عنوان برنامجي استلهمه كتابه الصادر بداية السنة :''ساعدونا على الطّلاق! دولتان الآن''(غاليمار).
عاموس عوز- يعني الشقّ الثاني من الاسم باللغة العبرية ''القوة'' "الشجاعة''- شخص عاشق للسلام لكن وفق تصوّر واقعي،بحيث بادر إلى توقيع عدّة عرائض، ويعارض بكيفية مطلقة أرييل شارون والليكود.رجل عملي،وناشط عنيد وصبور.
يعتبر ربما الكاتب الإسرائيلي الأكثر شهرة،وأحد الأصوات السياسية لحركة "السلام الآن''ورموزها.شارك بفعالية في الجدالات التي أفضت نحو مبادرة جنيف شهر دجنبر 2003،تناقش على امتداد أيام بأكملها مع الفلسطينيين حول مختلف الموضوعات التي شكّلت مصدرا لسفك الدّماء :عودة اللاجئين،الأراضي المحتلّة،الجدار الفاصل بين الدّولتين، في خضمّ تنامي الغضب و الألم،ثم توثيق كل بند من بنود التّسوية.
انتزاع توقيعات قصد إخراج إطار اتّفاق جنيف إلى العلن،يرتّب لدولتي إسرائيل وفلسطين،ويتيح لهما إمكانية العيش متجاورين،يفصل بينهما حدّ محكم.تقول إحدى عبارات كتاب عاموس عوز بين طيات كتابه''ساعدونا على الطلاق":
"نتخلّص من حلمنا بخصوص إسرائيل الكبيرة،مثلما يتخلّص الفلسطينيون من نفس حلم فلسطين الكبرى.إذا حدث تفعيل هذا الاتّفاق،لن يبقى في الشرق الأوسط مخيّم لاجئين فلسطينيين يرزح تحت اليأس،الكراهية،التعصّب''(ص 38).
حسب حركة ''السلام الآن''،يؤمن سبعون في المائة من المجتمع الإسرائيلي بضرورة بلوغ لحظة هذا الطّلاق،لكن يتوقّف الأمر حاليا على مبادرات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين كي يجعلوا الأمل معطى واقعيا،ثم يضيف عاموس عوز بأنّ :''رفض تسوية من هذا القبيل يقود نحو التعصّب،حرب تستغرق على الأقل مائة سنة''،ويسخر من أوروبا:لم تصنع قط على امتداد تاريخها سلاما بكيفية سريعة للغاية.
س- تقول بأنّ المجتمع الإسرائيلي''ديمقراطي،مترف،متحمِّس''،ولاعلاقة بوضعه مع حيثيات الصورة العدوانية والمتعصّبة التي تقدّمها وسائل الإعلام…
ج-بالتّأكيد.تختلف حقيقة العالم الواقعي عن العالم كما تظهره شبكة(سي.إن. إن).تكشف الحياة داخل إسرائيل عن هذا المعطى بكيفية لافتة للأنظار.لقد عُمِّمَت في كل مكان صورة مجتمع إسرائيلي غير ودِّي تتشكّل ساكنته من متديّنين متعصّبين تقارب نسبتهم ثمانين في المائة،وكذا جنود شرسين متسلّحين بالبنادق الرشّاشة يبلغ عددهم تسعة عشر في المائة،ولايتجاوز عدد المثقّفين الرّائعين رقم واحد في المائة،يدرجونني ضمنهم،حالمين جرّيئين يدافعون عن أطروحات السّلام ويتمسّكون عبثا بانتقاد توجُّهات الحكومة.تقييم نظرة خاطئة تماما لأنّها تخفي النّقاشات الحادّة بين الصقور والحمائم، وعمقها وكذا قوّتها الدرامية.المجتمع المدني الإسرائيلي بمثابة برلمان تحت سماء مفتوحة.إسرائيل بلد يطوي داخله ساكنة تتجاوز ثمانين في المائة مثلما يعيش أهل مارسيليا،برشلونة أو نابولي،ضمن أجواء تذكّر أكثر بفيديريكو فليني من إنغمار برغمان.أفراد علمانيون،يشكّلون طبقات متوسطة، مزعجون، مرحون، أنانيون، ملتهبون،وليسوا بملائكة،بل بعضهم مجرّد خنازير.لايهتمّ جميعهم بالإيديولوجية،وأغلبهم تحكمه مرجعية مادية ودنيوية،يرغبون كما الشّأن أيضا مع فلسطينيي إسرائيل،في بلوغ حلٍّ برغماتي لهذه الحرب وأن يعيشوا حياة سعيدة.الشّباب مهتمّ أكثر بالنّوادي الليلية الجديدة،وآخر صيحات المطاعم التّايلاندية وكذا البرنامج السينمائي في تل أبيب أكثر من أخبار قرى الغرب. لم أعرف أبدا تفاعلا فنيا سوى خلال هذه الفترة الحالية،على مستوى الأدب، السينما، المسرح، الفنون البلاستيكية،إلخ.
س-لكن الانتقادات نحو إسرائيل تنصبّ أكثر على حكومة أرييل شارون وليس الشعب الإسرائيلي؟
ج-ليس صحيحا.أعاين فقط تقارير إخبارية حول حياتنا الواقعية،غير دقيقة،أساسها صور نمطية.بالتالي،أجدني باستمرار أمام أخبار دعائية.لقد توقّف الحوار بين أوروبا المثقّفين وكذا المجتمع المدني الإسرائيلي.يشيرون إلينا بالأصبع،قصد شيطنتنا،مما يعكس كارثة بالنّسبة إلينا. نعلم جميعا استمرار الأدب،تراث الحرية خلال أسوأ أيام فترة الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا،عندما اقتُرفت جرائم فظيعة باسم فرنسا.لم يصرخ شخص سواء داخل إسرائيل أو في مكان ثان :''لنقاطع فرنسا''.بينما ألاحظ اليوم،مدى فظاظة المقاربة الإعلامية والفكرية حيال إسرائيل،مما يجعلنا نشعر بالنّبذ وقد حُشِرنا عند ركن زاوية.
س- هل تودُّ تأكيد فكرة عدم استيعاب أوروبا لمأساة إسرائيل…
ج-سنكون في الوقت ذاته''ملائكيين''و''أصحاب نزعة مانوية''.ينطوي النّزاع بين اليهود الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين على مختلف عناصر التراجيدية بالمعنى الكلاسيكي.يتصادم شعبان،وقد استند كل واحد منهما على مرجعيات يقينية بخصوص حقّه.يرغب الفلسطينيون في استعادة أرضهم،فلا يمتلكون وجهة بلدن ثان يعتبرونه وطنا لهم.أيضا،يعلن اليهود انتماءهم لنفس بلد الفلسطينيين ولايرغبون في مكان ثان.هاهما قوميتان بلا موطن،وينشدان نفس الوطن،داخل بلد كبير في حجم مساحة صقلية.ليس سوء تفاهم، بل تراجيدية،يمكن العثور على مخرج لها حسب أسلوب شكسبير،من خلال مشهد نهائي يغمره الأموات،وقد تحقَّقت العدالة أو على طريقة تشيخوف.هكذا يعود كل واحد إلى مكانه مستاء،كئيبا،منكسر الفؤاد لكنه يظلّ حيّا.
س-تحدَّثت عن تصوُّر مثقّفي أوروبا لهذه التراجيدية بكيفية ''هوليودية مفرطة"؟
ج-ينبغي على مثقّفي أوروبا التوقّف عن الاعتقاد بوجود جانب يهمّ الملائكة سواء في إسرائيل وكذا فلسطين.يبدو الاختيار الملائكي بسيطا،حين مناهضتهم الاستعمار وتردديهم دعوة القضاء عليه.استنكار الأبارتيد سهل.نفس الحكم يمكن إسقاطه على دعم فيتنام فترات مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية.لكن الصّراع الإسرائيلي الفلسطيني،ليس بفيلم ويسترن،وليس بدراما مانوية وثنائية المنحى،إما سوداء أو بيضاء.لايوجد طيّبون في هذه الجهة وأشرار يجتمعون عند الجهة الأخرى،كما الشّأن مع السيناريوهات الهوليودية الساذجة.إنّها دراما مرتبطة بهذه الأرض،ينبغي تفكيكها.أتفاجأ حين رؤية مثقّفين أوروبّيين يبحثون ثانية بسذاجة عن''الطّيّب''الذي يربح الرهان ثم ''الشقيّ''الذي يخسر.أقول، لهؤلاء :''اصنعوا السّلام وليس الحبّ''.
س-هناك بحسبك تقليد آخر بخصوص التزام فكري،لايقدّم دروسا كثيرة،معطى قادك نحو صياغة وتدبيج ''مبادرة جنيف''…
ج-أنتمي إلى تيار مختلف للغاية،معتدل،اشتراكي،لايعتبر المثقّفين ضمن تصوّره كقضاة عادلين بل فريق مرحِّب وفعّال. إذا وصلتُ إلى مكان حادثة سير والضحايا ينزفون دما،فلا يمكنني حينها الشّروع في توجيه عبارات اللّوم إلى السّائق المتهوّر ثم تقديم شكوى.سأحاول بداية العمل على وقف النّزيف وتقديم الدّعم إلى الضحيّة.تنتمي هذه المقاربة الفكرية إلى تقليد مضياف.عندما نستحضر تطلّعات الفلسطينيين البراغماتيين،تجري كل الأمور مثلما يعمل فريق من الأطباء،بحيث يقع أحيانا الاختلاف حول التّشخيص،أو العلاج.لكن يُطرح أمامنا عمل طبي يلزمنا جميعا القيام به.
تقديم : شكّلت هذه المحاور مضمون تحقيق هيّأته جريدة لوموند،عن غزة وحماس بعد الهجمة البربرية الإسرائيلية العسكرية يوم 27 دجنبر 2008.
بعد مرور عقدين عن معطيات تلك المرحلة وجزئياتها،وقد اختفت عن المشهد مجموعة من صانعي القرار الواردة أسماؤهم في هذا التوثيق التاريخي،لكن أسباب الصّراع وطبيعة معطياته لازالت تقريبا نفسها،مثلما كانت دائما منذ بداية النّكبة وتوطّد طبيعة الزواج الأبدي بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية،من أجل اجتثاث كلّ دواعي السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.
أولا- حوار مع أنطوني كورديسمان،المسؤول الكبير السابق في جهاز الخارجية والدفاع :
حسب تصوّر أنطوني كوردسمان، محلّل بالمركز الاستراتيجي للدراسات بواشنطن، ومستشار سابق للسيناتور جون ماكين في قضايا الأمن القومي،تتجلّى ثلاثة حلول لحسم قضية غزة :
ـ أن تبقى غزة مخيَّما ضخما للسُّجناء تحت سيطرة حركة حماس.
ـ أن تحتلّها إسرائيل من جديد.
ـ استعادة حركة فتح زمام القيادة، وهو أفضل حلّ في تقديره.
س ـ ما هي في نظركَ أهداف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة؟
ج- يكمن الإشكال في أنّ إسرائيل لم تحدّد هدفا استراتيجيا.هل يتعلّق الأمر بتحجيم قدرة حماس على الإساءة إليها، أو تحويل غزة إلى منطقة تتوقّف ممارسة عداوتها تحت إشراف إدارة سياسية بديلة؟ لكن الأمثل بالنسبة لإسرائيل،خلق فراغ حول الجماعة الإسلامية، وتهيئ الأجواء المناسبة داخل غزة قصد التّمهيد لعودة حركة فتح إلى السلطة. يشكّل هذا المسعى،انتصارا استراتيجيا. هل يمكن بلورته على أرض الواقع؟ لا أظنّ.
س ـ لماذا تمثّل عودة حركة فتح "حلاّ مثاليا"بالنسبة لإسرائيل؟
ج- هناك ثلاث إمكانيات. أن تبقى غزة معتقلا كبيرا بسماء مفتوحة، تحت سيطرة حماس. أو تحتلّها إسرائيل ثانية.قد تستعيد حركة فتح زمام الأمر،مهما كانت تحفّظاتها الحالية. يتناسب الحلّ الأوّل، في جانب منه مع الوضع الراهن. بينما، لاترغب إسرائيل في التصوّر الثاني.لذلك، يبقى المعطى الثالث هو الأفضل. إذا لم يظهر تأثير معيّن، فقد تطمح إسرائيل إلى وقف إطلاق النار تحت مراقبة دولية بهدف كبح قدرات حماس على التحرّك. غير أنّ الأمور ستظلّ في العمق على حالها.بوسع قوّة دولية ضبط الأمن،لكن غزة تمثّل باستمرار حالة حرجة، مادامت نسبة البطالة تصل تقريبا إلى %80.
س ـرفضت إسرائيل دائما قوّة دولية للفصل.لماذا يصير اليوم هذا المطلب مناسبا؟
ج- لاأتكلّم عن قوّة تدخّل بل مراقبين دوليين.تختلف غزة عن الضفّة الغربية: لاتعتبر إسرائيل أبدا القطاع، جزءا من أراضيها. إذا تعلّق الأمر بانتشار على امتداد الخطّ الأخضر (حدود إسرائيل قبل احتلال الأراضي الفلسطينية سنة 1967)، سيكون ذلك أكثر تعقيدا، غير أنّه ممكن حول غزة.مهما فعلت إسرائيل عسكريا دون حلّ سياسي واقتصادي، فلا يمكنها تقديم أيّ شيء سوى ربح مزيد من الوقت إلى غاية المجابهة القادمة. بالنسبة لما تبقى،ترسّخ الوضعية الحالية سياسيا كل ما يعتبره العالم العربي والإسلامي راديكاليا. تكمن الوسيلة الوحيدة،بهدف التصدّي لذلك في الحصول على منفذ سياسي لكن الحظوظ ليست متوفّرة اليوم.
س ـ ما الأثر الحاسم لهذه العملية الإسرائيلية على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؟
ج- يرتكز الأساسي على تحديد الأثر الحاسم للصّراع الإسرائيلي الفلسطيني. من الضّروري،أن تبرز واشنطن للبلدان العربية والإسلامية،وجود مجموعة نقط التقاء مشتركة معهم. يكمن المفتاح في المحافظة على مصداقيتنا، ونظهر لهم عدم سعي الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة عليهم. لكن سواء حدثت أزمة في غزة، أم لا، لن تتّسم الإدارة الأمريكية بالفاعلية نحو الشرق الأوسط يوم 21 يناير.يتطلّب وضع استراتيجية،وتعيين المشرفين عليها، شهورا عديدة.حينما يتقلّد باراك أوباما منصبه، ستظهر وقائع جديدة على الساحة. من الضروري بالنسبة إليه،إعطاء السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني أولوية أمريكية جوهرية. بناء على الصعوبات السياسية،تقتضي الخطوة الأولى التنسيق مع الأوروبيين وكذا حلفائنا من أجل تحسين وضعية الفلسطينيين الاقتصادية،وإن لم يتبلور بعد هذا الاختيار. في الواقع، أكّدت توصية دينس روس ومارتن إنديك،مستشاران سابقان للرئيس كلينتون في قضايا الشرق الأوسط،على أنّ السّعي نحو طرح شمولي،يعتبر الأفضل.لقد ظهر مسار المفاوضات التدريجي غير عملي: مع كل محطة، قد يمارس المتطرّفون من كلا الجانبين تأثيرا قصد الحيلولة دون تطوّرها. إلا أنّ الموقف منقسم بين الطّرفين، ثم تتعقّد القضية أكثر، في حالة فوز ليكود بنيامين نتنياهو بانتخابات 10 فبراير.
س ـ كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، أن تتصوّر وحدة حكومة وحدة فلسطينية وطنية، طريقة لإدخال حماس إلى المفاوضات؟
ج- إشكالية هذا الاقتراح السعودي،مدى معرفة وجود عدد كاف من العناصر المعتدلة ضمن صفوف حماس،تجيز الالتحاق بحكومة فتح قادرة على التّفاوض مع إسرائيل وإخماد الصّراعات المقسِّمة للصَفَّ الفلسطيني.تتوق بعض شخصيات حماس إلى تسوية، لكن قيادتها تتألف بشكل واسع من عقائديين متصلّبين، بحيث أنّ كل تفاوض يحدث بسرعة صراعا فلسطينيا داخليا.السؤال الحقيقي: ضمن أيّ نطاق قد تضعف حماس أكثر،بغية تمكُّن محمود عباس من إعادة السلطة الفلسطينية إلى مركزها؟ التوقّع غير ممكن.تظلّ مسألة رؤية سلام حقيقي سنة 2010 أو 2011 محدودة جدا،حتى دون استحضار هذه العملية العسكرية.يفتقد هذا الطّرف أو ذاك،كثيرا على المستوى السياسي بخصوص معطيات القوّة أو الوحدة. لذا، تتطلّب التّسوية النّهائية وقتا.
تقديم :أجرى هذا الحوار مع غسان كنفاني،كاتب سويسري متخصِّص في أدب كنفاني،قبل أسابيع من اغتيال صاحب''رجال في الشمس'' يوم 8يوليو 1972،بالتالي تندرج مضامينه ضمن الوثائق التّاريخية الأساسية قصد الإحاطة ببعض جوانب تراث كنفاني.
س-هل بوسعكَ غسان كنفاني أن تحدّثنا عن تجربتكَ الشّخصية؟
ج-أظنّ بأنّ تاريخي يعكس وسطا فلسطينيا تقليديا جدا.غادرتُ فلسطين في سنّ الحادية عشر وأنحدر من أسرة تنتمي إلى طبقة متوسطة.كان أبي محاميا ودرستُ في مدرسة فرنسية تبشيرية.فجأة،تَفَكَّكَتْ أوصال عائلتنا المنحدرة من الطبقة الوسطى ثم تحوَّلنا إلى لاجئين،فورا توقَّف أبي عن العمل نتيجة أصوله المجتمعية العميقة.عندما غادرنا فلسطين،واصل أبي العمل لكن بلا معنى،فقد أرغمه الوضع على ترك طبقته المجتمعية والانحدار صوب أخرى أقلّ مكانة،مسألة ليست هيِّنة.فيما يخصّني،بدأت الاشتغال منذ الطفولة والمراهقة قصد تلبية حاجيات الأسرة،وأكملتُ دراساتي بوسائلي الذّاتية بفضل مهنة لاتستدعي تأهيلا أكاديميا عاليا،أقصد مُعَلِّما داخل إحدى حجرات مدارس القرية.كانت بداية منطقية،لأنّها وضعية أتاحت لي إمكانية مواصلة دراساتي في السلك الثانوي.بعدها التحقتُ بجامعة دمشق،شعبة الأدب العربي،طيلة ثلاث سنوات،لكنّي طُرِدتُ لأسباب سياسية وهاجرتُ إلى الكويت حيث مكثت عشر سنوات،بدأت خلالها القراءة والكتابة.أمّا بخصوص مساري السِّياسي فقد انطلق سنة 1952،وأنا في عمر الرابعة عشر أو الخامسة عشر.خلال السنة نفسها،أو الموالية 1953،التقيتُ في دمشق صدفة للمرّة الأولى الدكتور جورج حبش.كنت أشتغل مدقّقا للاختبارات داخل مطبعة،لاأذكر تحديدا من عرّفني به،غير أنّ أواصر علاقتنا تبلورت منذ تلك اللحظة.التحقتُ فورا بصفوف الحركة القومية العربية وحينها انطلقت فعليا حياتي السياسية.خلال فترة تواجدي في الكويت،أظهرت فاعلية سياسية داخل صفوف تلك الحركة،التي تمثِّلها حاليا أقليّة مهمّة داخل الحكومة الكويتية.سنة 1967، تلقّيتُ اقتراحا بالانضمام إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،الفصيل الفلسطيني لحركة القوميين العرب.سنة 1969،انتميتُ إلى هيئة تحرير مجلة''الهدف"حيث أواصل الاشتغال.
س- هل بدأتَ الكتابة عقب دراساتكَ للأدب العربي؟
ج- لا،أعتقد بأنّ اهتمامي بالأدب العربي بدأ قبل هذه المرحلة.أحسّ بكونه جاء حصيلة تركيب نفسي،إن كانت ذاكرتي جيّدة.قبل الرّحيل عن فلسطين،درستُ في مدرسة فرنسية تبشيرية،مثلما أشرتُ سابقا.بالتالي،لم أمتلك لغة عربية رغم أنّي عربيّ ،وضع خلق لديّ عدّة مشاكل،وسخرية أصدقائي نتيجة عدم تمكّني من اللغة العربية.لم أختبر هذا الأمر حينما كنت في فلسطين،بحكم وضعي الاجتماعي.لكن عندما غادرت،ومعرفتي بأصدقاء جدد انتموا إلى طبقة اجتماعية أخرى لاحظوا من الوهلة الأولى ضعف مستوى عربيتي وتوظيفي تعابير غربية خلال أحاديثي،ممّا دفعني قصد التخلّص من المعضلة التركيز على اللغة العربية.أستعيد واقعة تعرُّضي لكسر على مستوى القدم نتيجة حادثة سير،سنة 1954 إن لم تخني الذاكرة،فأرغِمْتُ على المكوث طريح الفراش طيلة ستّة أشهر.شكّلت الحادثة فرصة لدراسة العربية بكيفية فعلية.
س-يمكن الاستشهاد حسب اعتقادي بأمثلة عديدة عن تاريخ شخصيات ''أضاعت''لغتها ثمّ سعت إلى استرجاعها ثانية.هل تتصوّر بأنّها عملية تؤدّي إلى تطوّر الشخصية سياسيا؟
ج-لاأعرف،قد يكون المنحى كذلك.فيما يخصّني،أضحيتُ مسيّسا بكيفية مختلفة. انتميتُ مبكرا جدا إلى عالم السياسة خلال فترة حياة المخيّمات بحيث عشتُ في تماسٍّ مباشر مع الفلسطينيين و مشاكلهم من خلال بالتالي اختبرتُ حقبة طفولتي هذا المناخ الحزين و الوجداني.لم يكن صعبا في غضون ذلك اكتشاف الجذور السياسية للسياق الذي يحيط بي.عندما شرعتُ في التّدريس،واجهتُ صعوبات كبيرة مع أطفال المخيّم،ينتابني الغضب عندما أرى طفلا نائما أثناء الحصّة،فيما بعد اكتشفتُ ببساطة علّة ذلك : يشتغل هؤلاء الأطفال ليلا،يبيعون الحلوى أو العلكة وأشياء من هذا القبيل داخل قاعات السينما والأزقّة.طبعا،يأتون إلى الفصل مرهقين.معطيات وضعية تهتدي بالشخص فورا نحو أصل المشكلة.حينها اكتشفتُ بوضوح أنّ منام الطّفل ليس استخفافا بي أو امتعاضه من التعلّم،ولابكرامتي كمدرِّس،بل مجرّد انعكاس لقضية سياسية.
س-إذن ساهمت تجربتكَ في التّدريس على تطوير وعيكَ المجتمعي والسِّياسي؟
ج-نعم،أذكر حدوث هذا الأمر فورا ذات يوم.كما تعلم،يدرّس معلِّمو المدرسة الابتدائية مختلف المواد،بما فيها الرّسم،الحساب،الانجليزية،العربية ودروس أخرى.كنتُ بصدد محاولة تعليم الأطفال كيفية رسم فاكهتي تفّاحة وموز حسب البرنامج المقترح من طرف الحكومة السورية،مادامت الضرورة تقتضي الامتثال للمنهاج الدراسي.خلال تلك اللحظة،وأنا أتوخَّى رسم الصّورتين على السبُّورة بشكل أفضل قدر المستطاع،لكنّي أحسستُ بشعور الاستلاب وعدم الانتماء؛وأتذكّر إلحاح شعور إبّان تلك الفترة يلزمني بضرورة القيام بشيء معين،فقد أدركتُ حتى قبل تأمُّل وجوه الأطفال الجالسين خلفي،أنّهم لم يكتشفوا قط الفاكهتين المقصودتين،لذلك تمثّل آخر اهتماماتهم،بحيث تنعدم أيّ علاقة بين هؤلاء الأطفال والصّورتين.تحديدا،العلاقة متوتّرة بين مشاعرهم وتلك الرسوم،وليست على مايرام.جسّدت معطيات اللحظة منعرجا محوريا،وأستعيد تماما تلك اللحظة الخاصة من بين جلِّ وقائع حياتي.هكذا،بادرتُ إلى محو السبّورة ثم طلبتُ في المقابل من الأطفال أن يرسموا مخيّما.بعد مرور أيام،حضر المفتِّش إلى المدرسة،ثمّ كتب تقريرا مفاده انزياحي عن إطار البرنامج المحدّد من طرف الحكومة،تأويل يعني بأنّي مدرِّس فاشل.قادتني مباشرة إمكانية الدّفاع عن نفسي نحو القضية الفلسطينية.تراكم خطوات صغيرة من هذا القبيل يدعو الأفراد كي يتّخذوا قرارات تطبع كل حياتهم.
س-تعليقا على هذه الإشارة،أعتقد بأنّه حين انخراطك في الفنِّ،باعتبارك اشتراكيا في كل الأحوال،انطلاقا من موضوع رسم الفاكهتين،حاولتَ إعادة ربط الفنِّ مباشرة بالمجالات الاجتماعية،السياسية والاقتصادية.لكن مايتعلّق بكتاباتكَ،هل ترتبط بحقيقتكَ ووضعيتكَ الحالية،أو تأتي من رافد إرث أدبيّ؟