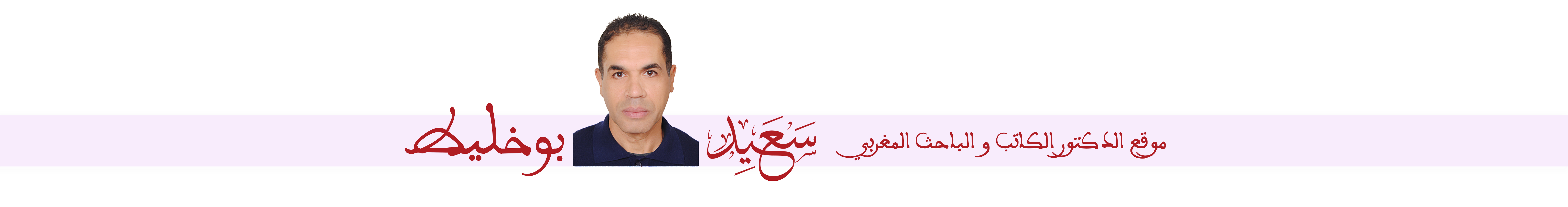
عند طرح سؤال إمكانية رصد الترجمة لدى جماعة بشرية معيَّنة،تتجلَّى حينها فورا شرارة التَّجاذب الجدلي بين الهاجس الفردي ثم الاشتغال الجماعي،أو بالأحرى التنظيم والهيكلة المؤسَّساتية:كيف يشتغل الحدَّان المتلازمان؟مستويات تكاملهما واختلافهما؟أين مكمن مفاصل حرية الفردي في إطار هذا الهاجس العام؟ما الذي يضيفه أحدهما للثاني؟هل بوسع الفرد أن يكون مذهِلا،دونما حاجة إلى تعضيد الموضوعي؟مثلما يلحُّ سؤال قدرات تطوير المجتمع لمنظومته بكيفية دؤوبة،ارتباطا بمكوِّن بشري منهكٍ ومشلولٍ ومعطَّلٍ، إلخ؟موقع كيان الفرد الواحد وانبثاق ممكناته الذاتية الخالصة،الأسطورية،من عدمه.
الترجمة واجهة معرفية صميمة،ضمن مرتكزات أخرى،لذلك عندما نسائل وضع الترجمة في الجغرافية العربية،نلامس حقيقة وأساسا الهاجس المعرفي ودرجات حضوره.يبدو،أنَّ الجواب على استفسار من هذا القبيل،في غير حاجة إلى أدنى مبرِّرات رقمية،وبراهين كمِّية،قصد إبراز الإيجابي أو السلبي،تكفي بهذا الخصوص مجرَّد معاينة مباشرة؛بإلقاء نظرة بانورامية،حتى يستشفَّ الملاحظُ حقيقة المشهد وفق تفاصيل البؤس الكبيرة.
إذن،الترجمة ابنة هذا الواقع اللا-تاريخي على جميع المستويات،إن استطاعت أصلا الارتقاء كي تغدو مؤسَّسة مُهَيْكَلة قانونيا ومعرفيا وإنتاجيا،بمعنى سلطة معنوية تمتلك بكيفية مستقلِّة تاريخا وحاضرا ومستقبلا،وتؤثَّر بفاعلية على مستوى تطور المجتمع وتغيير حصيلة أنساق رؤاه العامة من مرحلة إلى أخرى.
يسهل الإقرار من الوهلة الأولى،بأنَّ الترجمة لم تبلغ عندنا أفق المنظومة المؤسَّساتية،المحكومة بقانون وتطوُّر ذاتيين،في علاقة تفاعلية خلاَّقة مع السياق المجتمعي حسب قانون الجذب والتأثر والتأثير.إنَّها غاية الآن،تعكس في الغالب الأعم،ممارسات فردية ومبادرات شخصية،ينهض بأعبائها أفراد بعينهم،بناء على شغف خاص،ولم تترسَّخ بعد كمشروع مجتمعي بنَّاء،يمكنها وضع المجتمع برمته على سِكَّة منظور تاريخي وكوني. منحى،لازال فاترا،متعثِّرا،بطيئا،مترامية أشلاؤه بين رغبات أفراد يقومون بهذا العمل تحت وازع هواجس ذاتية غير محكومة عموما بنسق فكري ملهِمٍ،محفِّزٍ،سيشكِّل لامحالة نواة جاذبية أوراش عدَّة،تؤسس وتهيكل شتات الأعمال الفردية،المتناثرة هنا وهناك،قصد الانتقال بها وجهة مستوى المشروع المعرفي المجتمعي الذي يتوخى تحقيق نهضة شاملة،وطفرة تاريخية نوعية؛مثلما دأبت الترجمة على فعله دائما بين طيات مختلف الثقافات الإنسانية،فلا نهضة بدون ترجمات،والأخيرة بمثابة جسر لكل منظومة مدنية مجتمعية حقيقية،تضع باستمرار خططا استراتجية لسيرورة المجتمع،بتطويره آليات الترجمة بمفهومها اللغوي والدلالي ثم القيمي؛فالترجمة منظومة قيم تربوية وأخلاقية.
أعيد التَّذكير بمقطع نصِّي تضمَّنه كتاب التَّحليل النفسي للنار :''يضمر الإنسان إرادة تعقُّلية حقيقية.نستخفُّ بالحاجة إلى الفهم مثلما تصوَّرته وفعلت حياله البراغماتية ومعها البرجسونية،بالاعتماد مطلقا على مبدأ الفعَّالية.لذلك،أقترح تصنيفا تحت اسم عقدة بروميثيوس مختلف الميول التي تدفعنا كي نعرف ضمن مستوى آبائنا،وأكثر منهم،ثم عند ذات مستوى أساتذتنا،بل وأكثر منهم''.
تضاف غالبا إشارة التمرُّد إلى مختلف الإشارات التي أضفيت على أسطورة بروميثيوس،بحيث نتحسَّس راهنية العقدة.نحتفظ فقط من أسطورة بروميثيوس غواية التمرّد.بناء عليه،تمتلك العقدة واقعية جليَّة.لكن ليس مستعصيا العثور على أثر ضمن أقدم الأساطير.سأشير إلى بعضها،حسب أسلوب علماء الإثنولوجيا(6)المحايد طوعيا.
مثلا،السَّرد المسهب لصاحبه جيمس فريزر،بين صفحات كتابه''أسطورة أصل النار''في بولينيزيا (ص 78)،بحيث نرى أبا يتجنَّب إخبار ابنه عن مكان وكيفية طهوه الطعام.يحذَر الأب من ابنه''المفعم بالسخرية والعاشق للهزل''.يدفع الفضول الطفل كي يسرق النار.
سرد مشحون بالوقائع،يرتدُّ إلى سجالات لانهائية.حينما سُرِقَت النار من القدامى، ينبغي إظهار مزيد من التمرُّد نحو الأب الذي يأمر ابنه كي :"لايحمل النار معه؛غير أنَّه مرة أخرى يفشل الفكر المتوازِن للأكبر سنّا أمام شيطنة الأصغر سنّا".
تنطوي كل سرقة،وعصيان على إحالة إلى بروميثيوس،فقد أضاف جيمس فريزر على نحو بديهي(ص 81) :''هناك شيء في أسطورة تونغا الفظَّة،يذكِّرنا ببروميثيوس الإغريق الكلاسيكيين''.
لاحظنا خلال هذا النصف الثاني من القرن العشرين انبعاث انفجار حقيقي ل''الإشكاليات''القومية والتباين الدائم على مستوى تعدُّدها وكذا طبيعتها،على الأقل مظهريا،مما يجعلنا ننقاد خلف اعتقاد مفاده عجز الماركسية عن استيعاب تلك القضايا.
تجلَّى التصور سلفا عند إيديولوجيي البورجوازية وكذا مفكِّرين،استلهموا الماركسية،لكنهم غير مرتبطين بالممارسة الثورية.يقود قصور للنظرية من هذا القبيل حتى ضمن صفوف عدَّة أحزاب تدعي الاشتراكية العلمية،نحو التجريبية،والمقاربات التبسيطية السريعة،وكذا إهمال ''تكامل الواقعة''.
مع ذلك،سيكون جحودا في حقِّ الماركسية حين افتراض عجزها عن تضمين الظواهر الحالية المركَّبة ضمن إطار تفسير نظري،وعدم السعي صوب استخلاص خطط عمل من أجل الممارسة.
وطن عربي ثم شعب يهودي،إشكالية الأمريكي الأسود وكذا الزنوجة،إيرلندا الشمالية واستقلال بروتاني،انطلاقا من تنوُّع وكذا تناقضات هذه القضايا يمكن بل يجب تطوير نظرية ماركسية حول الوطن قصد الإجابة عن الحركة التاريخية للإنسانية.
سأطرح بهذا الصدد بعض الإشارات فقط:
*المنهجية :
في الوقت الذي يختزل فيه البعض الماركسية إلى مجرَّد نزعة علموية (لوي ألتوسير)،وكذا موجة إنسانية(مكسيم رودنسون)،تبدو ضرورة التأكيد على مرجعية بعض النصوص المنهجية لكارل ماركس(مقدمة عامة لانتقاد الاقتصاد السياسي)ثم تطوراتها ضمن الدراسات الفلسفية للقادة الثوريين الذين واصلوا ذلك،وكذا التعمق فيها من طرف الفلاسفة الماركسيين المعاصرين الآتية أسماؤهم:
سانشيز فاسكيز (1)،إرنست بلوخ (2)،لوسيان غولدمان(3)،أنور عبد المالك(4)،ثم أساسا كارل كاوتسكي(5).
تقديم : دبَّجَ كارل ماركس خمسين صفحة حول إشكالية تحرُّر اليهود،للإجابة على أطروحات برونو باور أحد أساتذته القدامى الذي درَّسه اللاهوت في برلين خلال سنوات(1836-1840).باور لاهوتي بروتستاني،انكبَّ طويلا على دراسة حياة المسيح،لكنه طُرد من كرسي الأستاذية نتيجة انتقاداته الجرِّيئة سنة 1841،فأصدر بعد ذلك دراسات عدَّة لاذعة،أبرزها في هذا السياق اهتمامه ب''الإشكالية اليهودية''.
يلتمس اليهود الألمان التحرُّر.فمالمقصود بذلك؟التحرُّر المدني،السياسي.أجابهم برونو باور(1) :لايوجد شخص متحرِّر سياسيا في ألمانيا.بدورنا نحن الألمان لسنا أحرارا.كيف بوسعنا تحريركم؟أنتم اليهود أنانيون،تلتمسون لصالحكم،تحرُّرا خاصا،لأنكم يهود.يجدر بكم العمل،انطلاقا من صفتكم كألمان،بهدف تحقيق التحرُّر السياسي لألمانيا،ثم الاستناد إلى خاصيتكم البشرية،من أجل تحرير الإنسان،وضرورة الإحساس بالمجال الخاص لاضطهادكم وإذلالكم،ليس باعتباره استثناء عن القاعدة،لكن بالأحرى مايؤكِّدها.
إما يدعو اليهود إلى مماثلتهم بالمواطنين المسيحيين؟إذا اعترفوا بدولة مسيحية تستند على القانون،فإنهم يقرُّون حينها بنظام الاستعباد عموما.فلماذا تثير عبوديتهم الخاصة استياءهم،بينما ترضيهم العبودية في صيغتها العامة؟لماذا تهتم ألمانيا بتحرير اليهودي،إذا لم يهتم الأخير بتحرير ألمانيا ؟
لاتعرف الدولة المسيحية سوى امتيازات.يمتلك اليهودي في ذاته امتياز أن يكون يهوديا.وضعية أتاحت له حقوقا غير متاحة للمسيحيين.فلماذا يطلب بحقوق ليست له، ومن حقِّ المسيحيين؟
حين التماس انعتاقهم من الدولة المسيحية،يؤكِّدون ضرورة التخلِّي عن انحيازها الديني.لكن هل يتخلى اليهودي بدوره،عن تعصُّبه الديني؟بالتالي،هل من حقه مطالبة الآخر بالتنازل عن دينه؟
لايمكن للدولة المسيحية،بناء على ماهيتها،تحرير اليهودي.أيضا،يضيف برونو باور،لايمكن لليهودي الانعتاق في خضمِّ ماهيته.طالما تبقى الدولة مسيحية وبقدر بقاء اليهودي يهوديا،يكون الاثنان معا غير قادرين سوى قليلا،كي يمنح أحدهما التحرُّر،ثم يتلقاه الثاني.
بخصوص اليهود،ستظلُّ الدولة المسيحية متمسِّكة بوضعية دولة مسيحية. يلزمها،بطريقة تمييزية،السَّماح لليهودي كي ينفصل عن باقي المواطنين؛غير أنَّ مثل هذا الوضع سيغدو عبئا على هذا اليهودي نتيجة تأثير اضطهاد أوساط أخرى،خصوصا حينما يجد اليهودي نفسه في تعارض ديني مع الديانة السائدة.بدوره،فاليهودي غير ممكن بالنسبة إليه،الاكتفاء بوضعية حيال الدولة تشير إلى يهوديته،بمعنى شخصا غريبا :هكذا،يطرح مقابل القومية الحقيقية،قوميته الخرافية،ثم قانونه الوهمي ضد القانون معتقدا امتلاكه حق الانفصال عن باقي البشرية؛مبدئيا،لايشارك قط في حركة التاريخ ويترقَّب بلهفة مستقبلا مغايرا تماما لمستقبل الإنسانية مادام يعتبر نفسه عضوا منتميا إلى الشعب اليهودي والأخير بمثابة شعب مختار.
إذن،بناء على أيِّ أساس،ينشد اليهود التحرُّر؟تبعا لدينهم؟يمثل هذا الدين العدوُّ اللدود لدين الدولة.أو لأنَّهم مواطنون؟ينعدم وجود مواطنين داخل ألمانيا.أم لأنَّكم بشر؟لستم بشرا،بل ولا الفئة التي وُجِّه إليها النداء.
أضفى برونو باور على إشكالية الانعتاق اليهودي وضعا جديدا،بعد انتقاده الوضعيات والحلول القديمة لهذه الإشكالية.يتساءل عن طبيعة اليهودي المقصود بالتحرُّر،وكذا طبيعة الدولة المسيحية التي يجدر بها التحرّر؟يطرح نقدا للدين اليهودي،ويقارب التعارض الديني بين اليهودية والمسيحية،ثم يشرح لنا ماهية الدولة المسيحية،بخطاب جريء،واضح الفكر،عميق ثم وفق لغة دقيقة قدر صلابتها وفعاليتها.
كيف إذن عالج برونو باور الإشكالية اليهودية؟ما النتيجة؟صياغة السؤال وتسويته. انتقاد المسألة اليهودية بمثابة جواب عليها.هاهو الملخَّص :
يلزم بداية تحرير أنفسنا،قبل التفكير في تحرير الآخرين.
يتجلى الشَّكل الأكثر صلابة للتعارض بين اليهودي والمسيحي،في التعارض الديني.كيف السبيل إلى تسوية هذا التعارض؟بجعله مستحيلا.كيف نجعل مستحيلا تعارضا دينيا؟بإلغاء الدين.عندما يكتفي اليهودي والمسيحي في النظر إلى ديانتيهما،باعتبارها مجرَّد مستويات مختلفة ضمن تطوُّر العقل الإنساني،''جلود الثعابين''وقد سلبها الثعبان المسمى إنسانا،لن يتعارضا حينئذ دينيا،لكن في إطار علاقة محض نقدية،علمية،إنسانية.يجسِّد العلم وحدتهما.والحال،أنَّ العلم نفسه يقدِّم حلاًّ للتعارضات العلمية.